بقلم شيخنا القناص
المعنى الباطني للصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
إن لكل طقس من طقوس الدين، له معنى باطني، وما الطقس الظاهري إلا رمز، وعلى المرء أن يكشف معناه وغايته لكي يمارسه بمحب، بالجوارح والروح، وحتى لا يكون مجرد تمارين جسدية، أو كلمات ينطقها لسانه ولا يشعر بها قلبه...
وضروري أن نعرف المعنى الباطني لكل شيء، لأنه هو أساس المادي وهو مصدره، لأن لولا الروح لما كان هناك جسد، ولا يمكن للجسد أن ينمو أو يعيش بلا روح، وإنما يمكن للروح أن تستغني عن الجسد وتفارقه... فهي الأساس والمصدر، منها وإليها... ونرى في الوجود أن لكل شيء له معنى ظاهري وباطني، وإن كنت تحب وتمارس الصلاة قبل أن تعرف معناها الباطني، فلماذا لا تعشقها عندما يمكن لك أن تعرف معناها الباطني؟
هذه هي فرصتك..
إن الصلاة في معناها الحرفي، هي الصلة بين الطرفين، هي العلاقة بين الطرفين، لأن الله منّ على آدم وبنيه بثلاث خصال، واحدة لله، وواحدة لآدم، واحدة بينهما...
فأما التي لله، أن يعبده ولا يشرك به. وأما التي لآدم هي ما إن يعمل صغيرة ولا كبيرة من الحسنات فله عشرة أمثالها والعشرة بمئة والمئة بألف وأضعافها، وإن عمل سوء فواحدة بواحدة، وإن استغفر فالله غفور رحيم. وأما التي بين آدم وبين الله، فهي الدعاء والصلاة، والطلب والإجابة. فنجد أن الصلاة والدعاء هي صلة العبد بربه، أي كان نوعها ، إن كانت صلاة ركوع وسجود، أو تبتل وابتهال، أو دعاء وطلب... ومن خلال هذه الصلاة فإن العبد يجل جلال الله، ويقدس اسمه وسره... والعبد يزيد وقارا ونورا، لأنه يفتح أبواب السماء، ويجذب الملائكة حتى تستغفر له وتطهره...
إن إقامة الصلاة هي إشارة لناموس الواحدية التي تفرد بها الله، حيث أن الصفات الحسنى والأسماء تفرد بها جل جلاله، من خلال وحدانيته التي كانت منذ الأزل ، أرقى من الخلود والعدم...
أما الوضوء فهو عبارة عن إزالة النقائص الكونية التي يكون الجسد جزء منها، وللنفس نصيبا منها، كصفة المادة والفناء والموت، والغرور والكبر، وباقي الصفاة البشرية دون الإنسانية... وكون الوضوء مشروطا بالماء، والماء سر الحياة ومصدرها ، فهي إشارة إلى أن صفات النقائص الكونية لا تزول من العبد إلا عندما تنعدم هذه الصفات بانعدام الأنا الفردية، لتحيا الصفاة الإلهية التي هي حياة الوجود... فتموت الأنا الفردية الصغيرة، لتحيا الأنا الكبيرة الإلهية في هذا القلب الذي وسع رب السماوات والأرض... ولولا الصفات الإلهية لما كان للوجود عدم، حيث أشرق نورة الكريم على المعدومات، حتى أوجدها رحمة منه، وهو الكريم الذي يرزق ما يشاء من كساء وطعام، ونور وعلم وهدى... هو القهار الذي قهر الوجود حتى سجد مرتعدا .
وإن لم يجد الماء للوضوء، فإن التيمم يأخذ مكان الماء ليحقق الطهارة للبدن والنفس، إشارة إلى التزكية بالمجاهدات والرياضات الروحية... كالتفكر والذكر، والصلاة والصوم والتعبد والتهجد.
أما عن استقبال القبلة، إشارة إلى طلب الحق، لأن القبلة هي منهل الأنوار السماوية على الأرض، لهذا فإن استقبالها، لهو استقبال الأنوار، خاصة وأن الأرض عند خلقها بدأت تتمهد بداية من مكة ثم المدينة، ومن ثم سائر الأرض، لأن قبلا لم يكن للأرض وجود، فقد كان الماء فقط، فخلق الله من هذا الماء زبد، ويبس هذا الزبد ليكون أرضا يابسة بدايتها من أرض مكة حتى المدينة، ثم باقي أرجاء الأرض..
وكون العبد يستقبل القبلة ثم ينوي للصلاة، فإن النية هي إشارة لانعقاد القلب في هذا التوجه.
وتبدأ الصلاة في رفع اليدين وتكبيرة الإحرام، التي تشير إلى أن الحقيقة الإلهية أكبر وأوسع من أي شيء وأعلى من أن تتجلى أمام العبد في بصرة أو بصيرته حتى، فيبدأ يقرأ الفاتحة، والتي بها كل أسرار القرآن... التي تكون آياتها سبعة، بعدد السماوات والأرضيين، وبعدد أيام الأسبوع التي خلق الله بها الكون، وسبعة ألوان طيف (أحمر- برتقالي- أصفر- اخضر- نيلي- بنفسجي- وردي)، وغيرها ... إشارة إلى أن النور يأتي من ما هو أرقى شيء موجود، أعلى من الوجود، وهو (الله نور السماوات والأرض) إشارة إلى النور الإلهي الذي يرقي العبد كلما كان مستعدا لاستقبال الفيض الإلهي... ولأن الله قد خلق الوجود من أرض وسماوات وكواكب وأشجار وانهار، وحيوانات، إلا أنها كانت مبهمة، حتى خلق الإنسان ليكون خليفة الله، وقد أعطاه الإرادة هبة وصفة إلهية، وأول ما خلق، خلق العقل الذي عرض عليه الأمانة والميثاق الذي قبل الأمانة، التي لم تستطع لا الأرض ولا السماء حملها، فكان الإنسان هو فاتحة الوجود، فتح الله به أقفال الموجودات وعلمه الأسماء كلها (إشارة إلى العلم والوعي والمعرفة الحقائق الوحدانية الإلهية، وهي لا تزال قابعة موجودة في الوعي الباطني الإنساني، وما الديانات إلا لغاية التذكير، لأن الإنسان نسي هذه المعرفة، أفلا تتذكرون وتعقلون وتبصرون ؟؟؟) .
ثم يأتي الركوع، إشارة إلى أن العبد يشهد ويعي ويعرف أن الموجودات الكونية تنعدم ، أي تكون لا شيء بالنسبة وأمام التجليات الإلهية، لهذا يقول العبد "سبحان الله العظيم"، أي ما أعظمك يا الله، وما أحقر الوجود السخيف أمام حضرتك الإلهية وتجليات صفاتك وأسمائك العلية.
وبعد الركوع، يكون القيام من الركوع، وهو يعبر عن مقام البقاء، بعد أن تفنى الموجودات بوجود التجليات، وهذا ليس لكل الموجودات، بل يكون لمن حمد ربه، لهذا يقول العبد في هذا المقام "سمع الله لمن حمده"، لاسيما وأن الله خلق الخلق لكي يعرف، وكي يحمد ويمجد، لهذا فتكون ثاني آيات الفاتحة، بعد البسملة (الآية الأولى)، "تبدأ بالحمد لله رب العالمين" لأنها غاية الوجود أبدا.
ثم يسجد العبد لله، وهنا تكون الإشارة إلى سحق آثار البشرية ومحقها باستمرار ظهور الذات المقدسة العليا.. ومن ثم الجلوس بين السجدتين، وهنا يبدأ العبد يتفكر بالأسماء والصفات ويتحقق منها، وهنا يكون في مقام الصمت والتفكر والتأمل، وينصح في وقت غير وقت الصلاة بقراءة القرآن بهذه الوضعية وليس وضعية التربع، لأنها الأنسب لترتيل.
ثم السجدة الثانية، بعد التفكر، وهي إشارة الرجوع من الحق إلى الخلق، إي الهبوط من الأعلى إلى الأسفل على أرض الواقع... ثم يقرأ التحيات فيها إشارة إلى الكمال الحقي والخلقي، لأنه يعتبر ثناء على الله وتقديسه، والسلام على المرسلين، ثم السلام على عباد الله الصالحين، حتى يكون للسلام نور على الأرض وصدى تعود للمصلي... وفي النهاية، يكون التسليم على الخلائق النورانية التي تحيط بالمصلي لكي تباركه وترد السلام عليه.

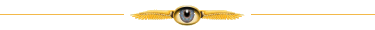
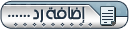







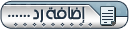
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه

























